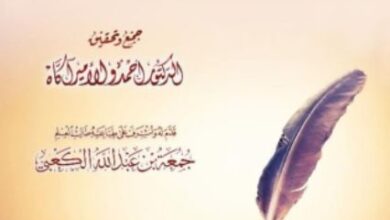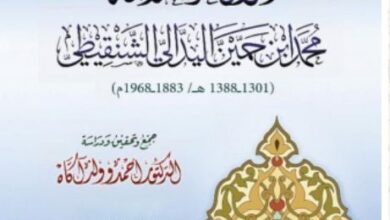*أما آن الأوان؟* *…/ بقلم: د. محمد الراظي بن صدفن.*
أما آن الأوان لأن تنتقل الرؤية القبلية والجهوية والعنصرية والشرائحية في موريتانيا *من جدلية الصراع إلى جدلية التوازن؟*
تعيش موريتانيا منذ تأسيس دولتها الحديثة صراعًا خفيًّا بين الولاءات التقليدية والانتماء الوطني، صراعٌ تجلّى في *مظاهر متعدّدة:* *القبيلة، الشريحة، الجهة، اللون… إلى آخره*. وهكذا تحوّل البناء الاجتماعي، الذي كان يومًا ما أداة للتكافل والتضامن، إلى عائق بنيوي أمام قيام دولة المواطنة والمؤسسات. لقد أصبحت مفاهيم القبيلة والجهة والشريحة وجوهًا مختلفة لأزمة الهوية السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ولكي نتجاوز هذه الإشكالات، لا بد من إعادة توجيه هذه الظواهر نحو *التوازن لا الصدام*. فالتنوّع الاجتماعي *ثراءٌ حين يُدار بعقل*، لكنه يتحول إلى خطر حين يُستغل في *تقويض المصلحة العامة.*
فالقبيلة يمكن أن تظل إطارًا للتعاون الاجتماعي، لكنها تفقد مشروعيتها حين تتحوّل إلى أداة نفوذ سياسي أو وسيلة محاباة.
*واختزال الأفراد في شرائحهم يكرّس التمييز ويقوّض تكافؤ الفرص*، فيما يجعل توظيف *الجهة* في الصراع السياسي منها عامل *تقسيم* بدل أن تكون *أداة تنمية*.
أما *العنصرية، فهي الأخطر بين هذه التحديات*، لأنها تهدم العدالة والمواطنة من جذورهما.
إن الدولة الحديثة لا تُبنى على أنقاض الانتماءات، بل على دمجها في هوية وطنية جامعة، تجعل من التنوع مصدر قوة لا هشاشة.
وهذا ما *ينسجم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تأسيس دولة موريتانية موحّدة وقوية،* متصالحة مع ذاتها، قائمة على *العدالة والمساواة والإنصاف* بين جميع مواطنيها.
وانسجامًا مع هذا التوجه الوطني، نقترح *جملة من الإصلاحات والتوصيات العملية:*
*1. إصلاح مؤسّساتي شامل ومتعدّد الأبعاد.*
*أ. في مجال التعليم:*
• إدراج قيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى.
• التركيز على الرموز الوطنية الجامعة التي تتجاوز الانتماءات الضيقة وتغرس في الأجيال روح المواطنة.
*ب. في مجال الإدارة:*
• فصل الوظيفة العمومية عن الولاءات القبلية و الشرائحية والجهوية، واعتماد معايير الكفاءة والجدارة.
• تفعيل الرقابة الإدارية والمالية لقطع الطريق أمام التوظيف الزبوني والمحسوبية.
*ج. في المجال السياسي:*
• سنّ تشريعات تمنع الخطاب القبلي أو الجهوي أو الشرائحي أو العنصري في الحملات الانتخابية.
• تشجيع الأحزاب السياسية على بناء برامج وطنية تنموية بعيدة عن الولاءات الضيقة، مع وضع معايير لاختيار المرشحين من أصحاب الكفاءات والانتماء الوطني الصادق.
*د. في مجال الثقافة والإعلام:*
• إنتاج مضامين إعلامية وبرامج توعوية تبرز قيم التنوّع والتعايش، وتكشف مخاطر العصبية بأشكالها المختلفة.
• تشجيع الحوار الوطني الصريح حول قضايا التهميش والإقصاء، لمعالجتها في إطار العدالة والمساواة.
*هـ. في مجال العدالة والقدوة السياسية:*
العدالة هي المدخل الحقيقي لأي إصلاح، فهي وحدها القادرة على تحييد مشاعر الظلم التي تغذي العصبيات.
ولا يمكن الحديث عن دولة المواطنة بوجود اختلال في تكافؤ الفرص أو فوارق شرائحية وعرقية في التوظيف والتمثيل السياسي.
كما أن القدوة السياسية تظل عنصرًا حاسمًا في بناء الدولة الجامعة؛ فحين يلتزم القادة والنخب بالحياد تجاه القبيلة والجهة واللون، يترسّخ في المجتمع مبدأ دولة القانون بدل دولة الولاء.
*الخلاصة:*
إن بناء دولة قوية لا يتم بإلغاء الهويات الصغرى، بل بإعادة ترتيب العلاقة بينها وبين الهوية الوطنية الكبرى.
فالقبيلة والجهة والشريحة ليست كيانات عدائية يجب محوها، بل طاقات اجتماعية ينبغي توجيهها لخدمة الدولة لا منافستها.
وحين يشعر المواطن — أيًّا كان انتماؤه — أن الدولة تحميه وتمنحه فرص العيش الكريم، فإن ولاءه الطبيعي سيتجه نحوها.
*لقد آن الأوان أن تنتقل موريتانيا من مرحلة التبرير إلى مرحلة التغيير، ومن التعامل العاطفي مع هذه الظواهر إلى معالجتها بعقلانية وشجاعة.*
*فـدولة المواطنة ليست شعارًا يُرفع، بل مشروع وعي وسلوك ومؤسسات، يتطلّب إصلاحًا متدرجًا وإرادة صادقة لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموريتانيين.*
*وحينها ستتحول القبيلة والشريحة والجهة واللون من أدوات صراع إلى عناصر توازن، ومن معوّقات تنموية إلى رافعات لوحدة وطنية متماسكة.